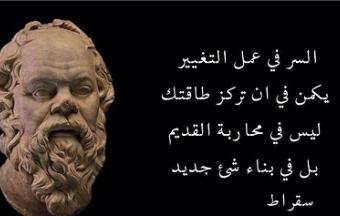شارل مالك وميشال شيحا من أركان الفكر الوطني
بِفَتيقِ المِسك، تُفسِدُ ذيوعَ الشّرورِ وإعصارَ الشّياطين، وتفرشُ لكلامِ الحقِّ طولَه، والحقُّ كالزيتِ يطفو على الدَّوام.
أعظم انجازات الأزمنة
شارل مالك دبلوماسيٌّ مُفَكِّر، الثِّقةُ به تُحفَة، وفِعلُه كَمَن يفكُّ أَسيرًا، هو السّالِكُ سبيلًا تَوَعَّرَ سلوكُه على مَن كان قبلَه، فلربّما معه رَمَقَ الحقُّ النّاسَ بِنَواظرِ سُعودِه. فبعدَ أن مزجَت الحروبُ الدّمَ بالدّمِ وأَزالَت السّلامَ عن مَقارِّه، وبطشَت بِوَجهِ العالمِ فصارَ أَسوَدَ الصّفحة، كان مالك مِمَّن دَعَوا إلى اتِّخاذِ المودّةِ خَليقةً، وأَنفقوا الكثيرَ من أيامِ دهرِهم لكي يتصبَّحَ البشرُ بالسّلامةِ مع كلِّ شمس. ولمـــّا كان الشرُّ في النّاسِ لا يَفنى وإن قُبِروا، لَزَمَ أن يكونَ السَّبقُ لنداءِ المجموعةِ التي نَصَّت بنودَ الشُّرعةِ الدوليّة، هذه التي تُؤمنُ بأنّ في الأرضِ مَجالًا لا تَضيقُ ظِلالُه، وكَسوةً لا يَحارُ معها عُريٌ، وعَينًا أَمّارةً بالرّحمةِ ومَغموضَةً عن كلِّ إساءة. وأمامَ حقيقةِ أنّ فئةً من النّاسِ تَسعَدُ بالوَفرة، وأخرى تكمَدُ بالحَسرة، كانت وثيقةُ الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسان، وهي أعظمُ إنجازاتِ الأزمنةِ في فُرَصِ السّلام، والتي توسَّعت في ألوف. وقد أَلَمَّ مالك بمسارِها التّشريعيّ وتولّى بين العمالقةِ ديباجتَها ومُراجعتَها، فدُمِغَت بفكرِه وخُتِمَت بحبرِ لبنان.
شاركَ شارل مالك «أينشتاين» في العملِ لثقافةِ الحياة، وكان بين الرّجلين وَلَعٌ لم يَأتِ عفوًا، فقد أطالا الحديثَ عن الفيزياء كما عن الحقِّ في الحريّة، هذه التي لا تُصانُ بسلوكيّاتِ الحروبِ واستهتاراتِ الأقوياءِ وهي الثُّقوبُ السوداء، بل بإِقبالِ النّوايا على نَبذِ الباطل. وثقافةُ الحياةِ مع مالك تبدأُ بثقافةِ التعلّقِ بها خارجَ إطارِ التملُّكِ واستعداءِ الآخر، بل من حيثُ هي نعمةٌ وكرامة. ولمـــّا كانت نهايةُ التّاريخِ بعيدةً زمنيًّا، صارَ من غيرِ المـُجدي السَّعيُ إلى تقريبِها بالصِّدام، فالحياةُ هي أَشرَفُ الأَحباب، والقيمةُ هي لِنُصرةِ الحياة لا لمـــُعاداةِ الأَحياء، حتّى أنّ واحدًا من المتطرِّفين في عِشقِ العَيش، قد بلغَ به الغُلُوُّ للقول: إنّ الدّنيا أحلى من الجنّة.
أمّا في الفلسفةِ الاجتماعيّةِ، فقد توقّفَ شارل مالك عند مكانةِ الفَردِ المــُقدَّسةِ وحمايةِ حقيقتِه كمواطِن، ولكنْ بعيدًا عن خطأِ أَسْطَرَةِ الأشخاص، والذي كرَّسَه البعضُ قاعدة. والأَسطَرَةُ أدبُ المدينةِ الفاسدة، ولها آثارٌ بَشِعَة، فكلّما تَمَّ تَذَكُّرُها ينتفضُ المجتمعُ العاقِلُ رفضًا لتقويضِ دعائمِ القِيَم. وساعةَ يحصلُ الابتعادُ عن منظومةِ القِيَمِ تلك ليتحوّلَ الإنسانُ إلى مجرّدِ رقمٍ مظلوم، يبدأُ الانحطاط، وهو الجَيبُ المَرقوعُ في رداءِ الزّمن. إنّ الفردَ مع مالك هو أصلُ السّلامِ والوحدةِ في الإنسانيّة، وليسَ إعلانًا فوقَ حائطٍ يُزالُ لدى أَقَلِّ زَخَّة، إنّه عِقرُ دارِ فلسفةِ الإجتماعِ وقَدَرُها، وهو التَّرتيباتُ التي تشكّلُ نهجَها، وهو نَجمُها غيرُ القابِلِ للاختزال. لذا، يرى مالك المــُنحازُ للإنسان، أنّ الفردَ كنزٌ يُثري ذاتَه والآخرَ بِخَلقٍ فكريٍّ حرّ، وبالقبضِ على الحقيقةِ الموجودةِ في داخلِه وإعلانِها، وبالمشاركةِ السلميّةِ المتفاعِلةِ مع التّراثِ الإنسانيِّ الحيّ، وبالمبادرةِ الخلاّقةِ المـــُتراكِمةِ مع المــُشتَرَكِ الكونيّ. وليس أمامَ الفردِ سوى أن يُكرِّمَ هذه الثَّوابتَ بالعنايةِ بها احترامًا وتطبيقًا، لأنّه إن لم يفعلْ، فالعنايةُ تعرفُ كيف تقتصُّ منه.
في الذّاتِ اللبنانيّةِ رئةِ الحريّات
كان لشارل مالك رسالةٌ في الفكرِ الدستوريِّ المـــُعاصر. فَبُرْجُ لبنانَ المــُـتجذِّرُ في قلبِ التاريخ، كما وردَ في نشيدِ الإنشاد، ليس جزءًا مسلوخًا عن مُقاطعةٍ ولها أن تستردَّه، وليس مساحةً رومنسيةً نحملُها في أشعارِنا ونشتاقُ إليها، إنّه قوميّةٌ رابِطَةٌ أو أمّةٌ كيانيّةٌ جامِعةٌ لها وجودٌ حرٌّ وسيادة، ولها مَن يؤمنُ بها. ولبنانُ مع مالك ليس ولايةً واطِئةً تتقلّصُ أو تتوسّعُ بحسبِ مزاجيّةِ جاراتِها، بل هو مَحمِيّةُ الاعترافِ الدّولي، يرتبطُ مواطنوه على تعدُّديتِهم، بعشقٍ كيانيٍّ وبِعَقدٍ علائقيٍّ واحدٍ، وتجمعُهم هويّةٌ وطنيّةٌ واحدة. لقد قدَّمَ مالك صيغةً أكثرَ نُضجًا لتَنسيجِ مفهومِ التّعاقدِ المواطنيِّ الذي يتَبَلوَرُ بمشاركةِ الجميعِ في الشّأنِ العام، فالمجتمعُ هو سيّدُ الدولةِ ووعاءُ السلطةِ ورائدُ استراتيجيّةِ الدَّمجِ حيثُ لا مُزاحِمٌ للرابطةِ الوطنيّة، وعلى الدولةِ أن تكونَ هي أنموذجًا قابِلًا للتَّواؤمِ مع حاجاتِ الناسِ وأهدافِهم. إنّ تَعزيزَ الهويّةِ الجامِعةِ على حسابِ الهويّاتِ الفرعيّةِ يُمَتِّنُ مبدأَ الانتماءِ إلى الوطنِ مسكَنِ البَدَنِ والرّوح، وكما أنّ الألحانَ لا تُؤْنَسُ إلاّ بالشّعرِ، فالهويّةُ لا تَطيبُ إلاّ بالولاء.
لم يَكن مالك بارِدَ النَّفَسِ مع الحداثة، وهو الذي حازَ الفضيلتَين: الثقافةَ والحِسَّ الوطنيّ، ففي ظلِّ الأنينِ والرَّنينِ، وهما أَقتَلُ عيوبِ الشّرقِ التي أَلِفَها جمهورُه وما زال، دعا إلى مواجهةِ الرجعيّةِ بوعيٍ جَمعيٍّ للفعلِ اللّيبيراليِّ الحاضِنِ لكفاحِ الإنسانِ من أجلِ الترقّي. لقد قاربَ مالك التقدّمَ في بُعدَيه الفلسفيِّ والإبداعيّ، وانتهى إلى أنّه لا يمكنُ إحرازُه بتَحجيبِ العقل بل بدوامِ الدّهشةِ أمامَ الوجود، وإطلاقِ عملِ الفكرِ الرّاغِبِ بمواكَبةِ الجديد. والتطوّرُ ليس بِدعةً، فالبدعةُ هي التَسَمُّرُ في الماضي، وعدمُ استحداثِ مُعجَمٍ ذي مَحمولٍ عصريٍّ على أنقاضِ التخلّفِ بالقوة. كلُّ ذلك لأنّ الذهنَ في بعضِ مجتمعِنا المـَشرقيّ، اعتادَ على قاعدةِ أنّ العَصرنةَ تَوأَمُ الاستعمار. لكنْ، وعلى الرّغمِ من قناعةِ مالك بأنّ الانفتاحَ إِكْسيرُ التقدّم، وبأنّ الحداثةَ تَحَوّلٌ متسلسلٌ إلزاميٌّ في بنيةِ المعرفة، فقد رفضَ الاقتباسَ الأعمى والتنكّرَ للخصوصيّة، من دون أن يشكّلَ ذلك حاجِزًا يمنعُ التّلاقُحَ والتأثّرَ بالنّافع. هذا الرّجلُ الآتي من القَلق، لم يتركْ قريحتَه حتى عَرفَ صَدرًا من العلم، واستوفى عُقودَ المعرفةِ التي تُنعِمُ على العقلِ بالصحّة، فدخلَت آراؤُه في مُرتضى الفكرِ لانفرادِها في بابِها. شارل مالك العالميُّ السِّعَةِ وفيلسوفُ السَّلام، أراه تركَ وصيّةً لجبابرةِ العالمِ تقولُ :إنّ الطّيورَ تأكلُ النَّملَ، وعندما تموت، النَّملُ يأكلُها.
الأصول في تكوين الأوطان
أمّا ميشال شيحا الذي لم يتحوّلْ معه العقلُ من حالٍ إلى حال، فهو فَتْحٌ أَنطقَه الفكرُ أعاجيب، فأمّنَ على لبنانَ الذي أعزَّ به اللهُ الدنيا من بينِ أمصارِها. لقد كتبَ لبنانَ فاستعذبَ في كتابتِه تعبَه، ومُختارُ كتابِه يُكتفى به عن جملةِ غيرِه. إنّ حظَّ لبنانَ فيه شبيهٌ بحظِّ أثينا القديمةِ في أرسطو، فالواحدُ منهما كان أوّلَ مَن فتّقَ أكمامَ الدستورِ الذي كان له من الاثنين نصيبٌ من عناية. فقد بَيَّنا غرضَ وضعِه القائمَ على مدمكةِ عقيدةٍ يَطمئنُّ لها شعب، وهي موجَزُ الأُطُرِ التي تعملُ الدولةُ بمقتضاها في كلِّ الشؤون، والتي بها يُدافَعُ عن المجتمع. وقد آثرَ شيحا الأخذَ بواقعِ المنعطفِ السياسيِّ في لبنان، ووُفِّقَ إلى إتمامِ منهجيّةٍ تقصَّتِ «الفكرةَ اللبنانية»، وأَطَّرَتْها ضمنَ ظواهرِ السياسةِ والاقتصادِ والاجتماعِ وطلّةِ الوطنِ على الخارج، فأسّسَت لكيانٍ منفتحٍ على الشرْقِ والغربِ، ومُستقلٍّ عنهما.
لم يقدّمْ ميشال شيحا هيكلَ دستورٍ قائمٍ من عدم، بل طرحًا «ثوريًا» بمعنى النّقلةِ من النقطةِ السُّفلى إلى النّقطةِ العليا لترجيحِ كفّةِ الصّواب، أو إنهاضًا لنظامٍ سياسيٍّ يحافظُ على السيادةِ والمواطَنةِ، ويضمنُ حياةَ الناسِ بالسماحِ لهم بفائضِ الحريّة. وهو لم يتحفّظْ في طرحِ المبادئِ التي تُنبئُ بهويّةِ أمّة، فالتحفّظُ ضربٌ من الجمود. وليس قولُه «إنّ لبنانَ لا يشبهُ إلاّ ذاتَه» يشكّلُ في وجودِه حيثيةً معزولة، بقدرِ ما يُعلِنُ عن أنموذجٍ راقٍ مُستساغ، أو عن أصدقِ حَظوةٍ يمكنُ تعميمُها حَلاّ لِما تتخبّطُ به الجغرافيّاتُ من إشكالاتٍ إثنيّةٍ أو عِرقيةٍ أو طائفية.
إنّ لبنانَ ميشال شيحا هو نمطُ تفكيرٍ يخصُّنا، وهو نسخةٌ مبتكَرةٌ لمفهومِ الوطنيةِ الصّرفِ بإشرافِ عقلٍ نَيِّر. وهو سلطةُ المعرفةِ التي فيها من الجرأةِ حيثُ يجبُ أن تكونَ الجرأة، وفيها من الطّرحِ ما يُحفَرُ في بالِ الوطنِ ليستمرّ، وفيها من الأسسِ ما يُنجِزُ صِراطًا مستقيمًا للإيمانِ بالأرضِ والحياةِ وإنقاذِ الحرية. وبهذا المعنى، يتعقّبُ شيحا الأصولَ في سِفرِ تكوينِ الأوطان، ويَبني اللحظةَ التأسيسيةَ الفارقةَ أو جسرَ العبورِ إلى التمدّن. وتتشكّلُ معه فلسفةٌ مؤنِسةٌ ذاتُ بُعدٍ شموليِّ النظرةِ للكون، فلسفةُ الضوابطِ والتوازنات، فلسفةُ بناءِ الوطنِ على العالميةِ التي هي بمنزلةِ المادةِ الأولى الهيولانيّةِ القابلةِ لصُوَرِها الشريفة.
إنّ حضورَ لبنانَ مع شيحا ثابتٌ في التاريخ، ولو وقعَتْ منه أجزاءٌ حيثُ يَشاءُ الإغفال، لأنّ شخصيةَ لبنانَ ملتصقةٌ بحتميةِ الوجود، وكأنّ لا وجودَ من دونِه. وهذا ليس تصويرًا كلاميًا لعلاقةِ الرَّجُلِ بوطنٍ رومنسيّ، أو نزعةً تخييليةً في فكرِه الفلسفيِّ - السياسيّ، أو خاطرةً شعريةً عابرةً (عِلمًا بأنّ ميشال شيحا اعتبرَ الشّعرَ أكثرَ خلودًا من أيِّ إمبراطورية، لأنّ فيه قوةَ الروح)، إنّه خطبةٌ موضوعيةٌ وازنةٌ يُشافِهُ بها دون تكلّفٍ أو مَشقّة، ويَصحُّ وقوعُها في المَقبوليّة. لم يكنْ إثباتُ الحضورِ في التاريخِ مجرَّدَ جهدٍ عقليٍّ عقيمٍ مع شيحا، بل كان حركةً جدليّةً قائمةً على منهجٍ مُرتَّبِ الأدوات، غادرَ بها الجمودَ الذي يميّزُ الأشياءَ الميتة. فالوطنُ ليس مؤقَّتًا ليمكنَ تعديلُه، بل هو شعبٌ خلاّقٌ منفتحٌ في موقعٍ إستراتيجيٍّ هو ملتقى الحضارات، ما جعلَ منه مِحطَّ اهتمامِ جماعاتِ الناسِ ومَمَرَّها إلإلزاميَّ الثابتَ على مرِّ الزمان، وهنا يكمنُ الخطرُ منه والخطرُ عليه.
العلاقة بين الوطن والمواطن
إنّ اللحظةَ التاريخيّةَ التي نمرُّ بها تجعلُ المشهدَ السياسيَّ يتعثّرُ برهاناتٍ إيديولوجيةٍ تُحدثُ انقسامًا في رسمِ الخطِّ الإستراتيجيِّ للوطن، لأنّ البعضَ اعتبرَ أنّ الأهدافَ التي خُتِمَ عليها لبنانُ قد تجاوزَتْها الصيرورةُ التاريخية. وفي إطارِ هذا السياق، تبدو الحاجةُ مسوَّغةً لاسترجاعِ المفاهيمِ التي في وثيقةِ شيحا (لبنانُ في شخصيتِه وحضورِه)، ليس لصقلِها بل للتصالحِ معها بتطبيقِها، وفي ذلك حيلولةٌ دون موتِ الوطنِ «الكلاسيكيِّ»، ومن دون تفريغِ الانسجامِ والتناسقِ بين مُكوِّناتِه. فالوطنُ تَرَسَّخَ مع شيحا جزءًا نَشِطًا في النسيجِ الثقافيِّ الشعبيّ، والمواطنون أصبحوا أناسًا متساوين في الحقوق، خارجَ منطقِ الأكثريةِ والأقلية، ومُؤهَلين للمواطنةِ وليسوا مُجرّدَ رعايا أو أتباع. وقد شكّلَتْ هذه الصياغةُ محطةً حاسمةً في البُعدِ الجيوسياسيِّ لمفهومِ الوطنِ والدولة، وتَجاوُزًا لا يقلُّ أهميةً عن أَثَرِ الثورتَين الفرنسيةِ والأميركيةِ في الفكرِ الدستوريِّ النهضوي، خصوصًا وأنّ عِلمَ الكياناتِ السياسيةِ لم يكنْ بعدُ رائجًا في خرائطِ المنطقةِ ولا في بالِ أهلِها.
لقد نقلَ شيحا إيديولوجيةَ العلاقةِ بين الوطنِ والمواطنِ من التّكليفِ إلى الحقِّ ولكنْ غيرِ المــُـتَفَلِّت. فبعدَ الحركاتِ التنويريةِ لم يعدْ جائزًا الحديثُ عن الطاعةِ المــُطلَقةِ والعبدِ والمولى، فالإنسانُ راحَ يبحثُ عن كرامتِه في حقوقِه ويطالبُ بها اللهَ والطبيعةَ والآخر. وفي رأسِ جدولِ الحقوقِ، تتربَّعُ الحريةُ المــُصانَةُ مع شيحا بالدستور، والتي لولاها لما كان للبنانَ قيمة، ولَضَاعَ في آنيّاتٍ زائِلة. لكنّ شيحا ربطَ الحقَّ والحرياتِ حُكمًا بمعادلةِ المسؤوليةِ كما ينصُّ عليها القانونُ المدنيُّ لا التكليفُ المــُتوارَث، والتي ينبغي أن تُطبَّقَ وتَسريَ مفاعيلُها على الجميعِ تحقيقًا لمبدأِ العدالة. وقد ردَّ شيحا بذلك على الذين انتقدوا الأنظمةَ الوضعيةَ وفسادَها من جهةِ تلويثِ فطرةِ الإنسانِ بالمظاهرِ المادية، وسيطرةِ القويِّ على الضعيفِ في صراعِ الأُمم، معتبِرين أنّ معرفةَ حاجاتِ الناسِ هي صفةٌ لا تتحقّقُ إلاّ في اللهِ الذي وضعَ التكاليفَ وأرسلَ مَن أَلْزَمُ البشريةَ بها فطاعَتْه.
يكفي إيمانُ ميشال شيحا بالأمةِ اللبنانيةِ نَصُّه الدستوريُّ الذي أَوجَبَ على رؤساءِ الجمهوريةِ المــُـنتَخَبين، بأن يُردِّدوا وهم يُقسمون يمينَ الولاء: «أحلفُ باللهِ العظيمِ أن أحترمَ دستورَ الأمةِ اللبنانيةِ وقوانينَها، وأحفظُ استقلالَ الوطنِ اللبنانيِّ وسلامةَ أراضيه». لكنّ ميشال شيحا بقيَ عاتِبًا على بعضِ هؤلاءِ مِمَّن أَغفلَ في قَسَمِه، ربّما عن عَمْد، أنَّ اللهَ عظيم.