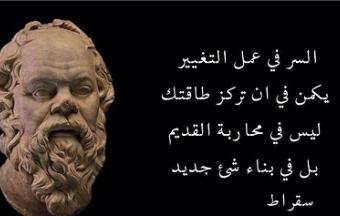المحاماة اللبنانيّة وجذورها الديمقراطيّة
كان كلّ من يوم "السبت" في الكتاتيب الدينيّة، ويوم "الإثنين" في المدارس الأخرى نهارًا سمج الاسم والطعم عند الأولاد، لأنّه فاتحة الأسبوع الطويل عليهم.
لقد علقت فعلًا ببعض الألفاظ إيحاءات شتّى غير واعية تجاوزت المدلول المباشر للكلمة وأغدقت عليها مفاهيم مستحدثة مضافة إلى معناها الأوّل:
ومن هذه الكلمات الواعدة، وغير المنجزة لكامل وعودها، لفظات طغت على الحياة اليوميّة واستساغتها الألسن واستمسكت بها وأكثرت من تردادها وكأنّها رأت في الإكثار من ذكرها عذرًا وصفحًا عن تقصيرها في تحقيق جميع المؤمّلات المعقودة حولها.
ويأتي في هذا السياق اليوميّ المتداول نفر من الكلمات المحظيّة التي تتسارع إلى الذهن كألفاظ الشرف والكرامة والعهد والوفاء والحرّيّة والعدالة والشعب وسواها.
ويلاحظ بشأن هذه الكلمات أنّ الفكر البشريّ يعلم استحالة إدراك أقصى المراد المودع في حناياها، لأنّه لا يخفاه أنّ تفسيرًا يعطى لها اليوم قد يعطّله تفسير آخر يستجدّ في الغد على غرار الاجتهادات المتعاقبة والمتباينة، وقد تتوالى التفسيرات والمفاهيم بشأنها متزاحمة، وكأنّها المرايا المتقابلة في ردهة لا تدرك العين منتهاها.
وفي معجم الحياة العامّة تتهادى إحدى اللفظات اختيالًا على سواها، وتملأ الإشادة بها الميادين الشعبيّة كافة في العالم، وهذه اللفظة الوهّاجة التي تتغنّى بها دون استثناء سائر الأنظمة السياسيّة، مستبدّة كانت أو متراخية، هي كلمة "ديموقراطيّة" التي تحوي من المعاني – المتناقضة أحيانًا – ما لا يقع تحت عدّ وحصر.
وتختلف الآراء حول تحديد وسائل تطبيقها ولا يختلف أحد في أنّ هدفها هو السعي إلى الارتقاء بالمجتمعات وإلى إسعادها، وإنّ غايتها القصوى هي إقامة دولة الحقّ وإرساء مجتمع الكفاية، الذي يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الحرّيّة، متّحدًا بأكبر قدر ممكن من العدالة، لدى جميع المواطنين في الدولة الواحدة.
وكان المحامون منذ قيام نقابتهم عام /1919/ قد أدركوا أنّ مسؤوليّات جسامًا ألقيت على عاتقهم وأنّ آمالًا عريضة شدّت إليهم وأنّ الرأي العام لن يهادنهم ما لم يحاولوا مضارعة دور المحامين لدى الجمهوريّة الفرنسيّة الثالثة، في ذلك العصر الذهبيّ للمحاماة في فرنسا حيث ارتبط القول الفصل في معظم الشؤون العامّة بالتوجيه والإرشاد الصادرين عن المحامين على صعيد السلطات الثلاث، التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة.
وقد ضمّت المحاماة اللبنانيّة في مستهلّ كيانها فئة من كبار الفقهاء موزّعين بين ذوي اختصاص في الشريعة وأحكام المجلّة، وبين رجال قانون متخرّجين من كبار معاهد الحقوق في فرنسا، وكان هؤلاء قد اضطرّوا إبّان الحرب الكونيّة الأولى أن ينتقلوا إلى مصر صيانةً لاستقلالهم الفكريّ وأن يقيموا فترة من الزمن يترافعون فيها أمام المحاكم المختلطة في القاهرة والاسكندريّة.
ولم يكن يخفى على الآباء المؤسّسين في المحاماة اللبنانيّة أي تحدّ كان يتعيّن عليهم أن يتصدّوا له وأن يغالبوه، حتّى تتساوى طموحاتهم وإنجازاتهم مع ما كان قائمًا من الجهاد المهنيّ والوطنيّ لدى المحامين في فرنسا أو في بعض الأقطار العربيّة في سياق الحركات الاستقلاليّة لديها، ولا سيّما في مصر حيث كان سعد زغلول ومكرم عبيد طليعة القانونيّين الذين غدوا في ذلك الزمن النموذج الحيّ للتفوّق المهنيّ.
وكان طبيعيًّا أن يكون الشعار المحرّك لعمل المحامين في لبنان _ عقب انتهاء الحرب العالميّة الأولى ورواج المبادئ الجديدة التي رسمها الرئيس ولسون (وفي طليعتها حقّ الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها)- عنوانًا جديدًا للحياة العامّة في العالم، عبر محاولة الالتقاء المتشوّق مع ما كان مسلّمًا بها من قناعة بأنّ الحرّيّة لا يمكن أن تعيش إلاّ تحت سقف الديموقراطيّة.
فنشأت تلك الإلفة بين المحاماة اللبنانيّة وبين الديموقراطيّة، وسرعان ما أدرك المحامون أنّ مفهوم الديموقراطيّة الموزّع بين معانٍ كثيرة لا يعدو كونه دائرًا في مجمله ضمن حلقة تنافسيّة تتبارز فيها مدرستان اثنتان، أحداهما تدين برجاحة الديموقراطيّة السياسيّة وهي المتطلّعة إلى صيانة الحرّية المرتكزة على إطلاق المبادرة الفرديّة، وترك الناس يتدبّرون شؤونهم وأمورهم بأنفسهم، في إطار اقتصار الدولة على حماية أمنهم ودرء العدوان عنهم.
والمدرسة الأخرى المدعوّة بالديموقراطيّة الاجتماعيّة هي تلك تصرّ على أنّ وجود الدولة ليس له من مبرّر راجح إلّا إذا كفلت الدولة للمواطنين الاستجابة الكاملة لمتطلّباتهم الحياتيّة اليوميّة، التي يأتي في عدادها _ عند أضعف الإيمان _ ضمان جماعيّ للمسكن الميسور والمدرسة المجانيّة ولمجمل الخدمات الصحّية وتلك المعنيّة برعاية الطفولة والأمومة والشيخوخة ولسائر التقديمات الحضاريّة المرفّهة.
ومعلوم أنّ ما بات متوطّدًا في تربية المحاماة الحرّة هو أنّ الخلق الديموقراطيّ لدى الحاكم الذي كان في الأزمنة الغابرة يفي وحده بحاجة الناس، ليس في مقدوره اليوم تلبية متطلّبات المجتمع إذا لم يكن مسندًا إلى نظام قانونيّ تأسيسيّ متكامل يصونها ويتعهّدها.
والديموقراطيّة في العالم عادت، بعد رقدة استمرّت أجيالًا طويلة، فتذكّرت عهدها اليونانيّ الذهبيّ فكانت لها أولى انتفاضاتها الكبرى عبر الثورة الفرنسيّة عام 1789، وهي ما تزال ترتقي صعدًا في ترسيخ مكاسبها ولا تبرح تتنوّع في تحديد ملامح وسمات وجوهها الجديدة المتعدّدة.
إنّها في عالم اليوم منقسمة علمًا وتطبيقًا إلى مذاهب شتّى يمكن ردّها جميعها _ كما سبق التنويه به أعلاه _ إلى نظريّتين أساسيّتين، متباينتين تقوم بينهما مدرسة تعتنق مفهومًا يحاول التوفيق بين النظرتين المتصارعتين.
النظريّة الأولى هي النظريّة التقليديّة التي كان معمولًا بها حتى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، وهي التي تحدّرت من تعاليم فلاسفة الجيل الثامن عشر في أوروبا وخلاصتها أنّ الحرّية هي حقّ طبيعيّ للكائن البشريّ وأنّ الشعب مصدر السلطة هو الذي يسوس نفسه بنفسه ويصون حقوقه وحرّياته عبر ممثّليه المنتخبين عن طريق اعتماد رأي الأكثريّة.
وهذه النظريّة معروفة بنظريّة الديموقراطيّة السياسيّة، وهي معتنقة لدى الولايات المتّحدة الأميركيّة ومعظم دول أوروبا الغربيّة، غير أنّها تتطوّر باستمرار.
وترتكز الديموقراطيّة السياسيّة إلى ما اتّفق على تسميته بالحقّ الليبراليّ وخلاصة مفهومه هو أنّ النظام الاجتماعيّ الأفضل هو الذي لا يلجأ إلاّ بالقدر القليل إلى الإرغام ويترك المبادرة للقوى الاجتماعيّة العفويّة.
فالمفهوم الشرعيّ للفكرة الليبراليّة لا يحدّد أهدافًا خاصةً للنشاطات الشخصيّة وليس للفكرة غايات معيّنة تتوخّاها من جرّاء عمل الأفراد والجماعات، وهذه الغايات هي موقوفة على تحرّك العزائم الخاصّة وفق هواها، لدرجة يصحّ القول معها أنّ من أهداف الفكرة الليبراليّة أنّ ليس لها هدف، ولا تطلب من الدولة سوى قدر قليل من السعي المحصور بحماية حرّيات ونشاطات الفراد.
وترتكز النظرة الليبراليّة إلى أنّ الحرّية هي هبة طبيعيّة، سابقة لوجود الدولة وينبغي أن يبقى الفرد في حذر من الدولة وفي مراقبة لها حتّى لا تعرقل نموّ هذه الحرّية بتصرّفات مسيئة.
وفي عمق مفهوم هذه النظريّة تشكيك في جدوى الدولة وفي صلاحها وهي تعدّ بشكل معلن أو خفي عدوّ الفرد. ولا يتطلّع المواطن إلى الدولة ولا يسلّم بوجودها إلّا مرغمًا وذلك في سبيل كفالة أمنه وسلامته وحماية ملكيّته وتغدو الدولة لديه وكأنها نوع من الشرّ الذي لا بدّ منه. ولذلك يتعيّن على المواطن أن يمسك بناصية هذا الخصم ويراقبه ويستطوعه حتّى يحول دون ضرره.
فالديموقراطيّة السياسيّة تعدّ في مفهومها البعيد المتعمّق ربقة وهيمنة من الفرد على الدولة.
ومن نتائج هذا المذهب الفكريّ وفي حصيلة منطق هذه النظريّة أنّ الفرد مدعوّ إلى أن يحدّد هو نفسه المسلك الذي يتعيّن على الدولة اعتماده عن طريق اختيار ممثّليه في عمليّة انتخاب حرّة.
وكلّ تضييق على الفكر وكلّ محاولة لفرض خيار أو لتعديل ميل في المواطن يجب في المذهب الليبراليّ أن يرذل وينبذ. فالديموقراطيّة السياسيّة تدلي بأنها مندفعة إلى الأمام بحرّية الرأي، وحرّية الصحافة، وحرّية الاجتماع، ولا تسلّم بالتوجيه وبعصمة الرأي الرسميّ والموقف الحكوميّ. وإنها تثير مقابل السياسة الموجّهة مبدأ حرّية التجارة والصناعة ومقابل التصميم والخطط الطويلة الأمد حرّية الفرد في نطاق الانتظام العام.
ومن سمات الديموقراطيّة السياسيّة – وفي عداد المآخذ عليها – أنّها تدرك أنّ أيًّا كانت الدوافع المنشّطة التي تحمل الشعب إلى صناديق الاقتراع، فلن يتمّ اقتراع مجموع المواطنين، وبالتالي لن تكون المجالس المنتخبة ممثّلة بالأمانة الكاملة للجميع. وفي المجالس ذاتها التي تتولّد عن الانتخاب، لن تصدر المقرّرات إلّا عن فئة من الممثّلين بمعنى أنّ حاملي المسؤوليّات والحكّام سيبقون دائمًا عاجزين بطبيعة التركيب الديموقراطيّ السياسيّ عن تمثيل الشعب بتمامه وكماله وسائر أفراده – لذلك يستقيم القول بأنّ الديموقراطيّة السياسيّة تبقى باستمرار وبمعرفة تامّة من معتنقيها حكم الأكثريّة ليس إلّا، في مجالسها الاشتراعيّة. وكذلك إنّ الذين يتولّون الأحكام من بين هؤلاء الممثّلين هم نفسهم يبقون باستمرار أكثريّة الأكثريّة لأنّ المقرّرات والتدابير المتّخذة في المجلس التشريعيّ من قبل الأكثريّة تنشئ هي ذاتها الحكومات ممثّلة للأكثريّة. والأكثريّة الممثّلة في الحكومات تعتمد هي ذاتها مقرّراتها بالأكثريّة والوزير ضمن هذه الأكثريّة هو الذي ينفرد ويوصي عادةً بالقرار المتّخذ ممّا يعني في عمليّة تحليليّة لهذه الأكثريّة أنّ المقرّرات في الديموقراطيّة السياسيّة هي وليدة فعل أقلّيّة أكثريّة الأكثريّة.
من هنا وجب على الديموقراطيّة السياسيّة أن تعير شأنًا كبيرًا إذا كانت ترغب في أن تكون أمينة لمبادئها إلى رأي الأقلّيّة المعارضة. وهذه المعارضة في نظام الديموقراطيّة السياسيّة هي المحكّ لمعرفة احترام النظام لنفسه وللحرّيات، حتّى جاز القول أنّ مناقبيّة الديموقراطيّة السياسيّة _ إذا كانت صادقة _ تكمن في احترام حرّية الأقلّية وأنّ حرّية الأقلّية منوطة بصيانة حقّها في المعارضة.
وبقدر ما يكون للمعارضة فيها ممارسة مسموعة لحرّياتها، بمثل هذا القدر تكون الديموقراطيّة السياسيّة وفيّة لذاتها وبارّة بميثاقها وأمينة لمبادئها.
وقد يكون وراء هذا التحليل الاستفادي للمدلول الصحيح في مكوّنات الأكثرية البرلمانيّة العاملة اليوم في المجالس التمثيليّة، أحد أكبر الأسباب التي دعت إلى ولادة وإلى تزايد المجالس والمحاكم الدستوريّة في العالم.
وبإزاء هذا المفهوم للديموقراطيّة الكلاسيكيّة هذه التي تنظر إلى الحرّية وكأنّها عطاء سابق لقيام الدولة ملازم لطبيعة المرء وقائم منذ ساعة ميلاده، وتنظر إلى الدولة وكأنّها ضابط لا بدّ منه لصيانة أمن وسلامة ممتلكات المواطن بشرط ألاّ تتدخل في شؤونه إلّا بالقدر اليسير الذي يصون له نشاطاته ولا يتجاوز على ما يدعوه المواطن حريّة تحرّكه التام في مجتمعه، نشأت في العالم مفاهيم لديموقراطيّة أخرى دعيت الديموقراطيّة الاجتماعيّة وأخذت الديموقراطيّة السياسيّة ذاتها بفعل باطنيّ من لدنها تخطو في بعض البلدان نحو هذه الديموقراطيّة الجديدة.
والديموقراطيّة الاجتماعيّة تتطلّع إلى الحرّية عبر منظار جديد وتعطيها تفسيرًا مختلفًا عن التفسير التقليديّ.
ومنطلق الديموقراطيّة الاجتماعيّة مسند إلى القول بأنّ الحرّية التي ترفع لها القباب والمنابر لدى الديموقراطيّة السياسيّة هي امتياز عقيم لدى الأكثريّة الساحقة من المواطنين في الدولة ما دام أنّه يتعذّر على هؤلاء المواطنين أن ينتفعوا بها ويتذوّقوا محاسنها.
ماذا يفيد الإنسان حرّية تفكيره إذا كان التعبير عن هذا التفكير يجعله عرضة لنقمة اجتماعيّة.
ما فائدته من مناقشة شروط عمله إذا كانت الأوضاع الاقتصاديّة تجبره جبرًا على الخضوع لمشيئة ربّ العمل.
ما هو كسبه من حقّه في حرّية تنظيم حياته، إذا كان هاجس الطعام اليوميّ يستنفد كلّ أوقاته.
ما هو فضل حرّيته في تدبير أموره وأين هي كرمى تفتّح شخصيّته طالما أنّه لا يملك الحدّ الأدنى الذي يساعده على العيش وعلى تدارك قلق الغد ومباغتات المستقبل.
وتتابع الديموقراطيّة الاجتماعيّة مرافعتها فتذكر بأنّ ترك حبل الحرّية على الغارب قد أدّى عبر التلازم القائم بين المبادرة الفرديّة والمضاربات والمنافسات الحرّة غير المنظّمة إلى إنشاء احتكار للسلطات الاقتصاديّة في المجتمعات بين أيدي طبقة اجتماعيّة واحدة مهيمنة.
وإنّ حصيلة هذا الاحتكار وهذا الاستئثار كان تعميق الفوارق والتفاوتات بين الناس وإلى انفراج مسافات الخلف بين ثروات فاحشة للبعض وافتقار مدقع مع ما يلزمه من مرض وجهل للآخرين.
فكان لا بدّ أن يلتفت بالأولويّة إلى تصحيح هذه الأوضاع عن طريق تصويب معاني الحرّية.
فالحرّية ليست هبة سابقة لوجود الدولة كما تبدي الديموقراطيّة الكلاسيكيّة لأنّ مثل هذه الحرّية التي تدعو الفرد أن يفعل ما يشاء هي وهم من الأوهام يزول ويتلاشى في الساعة التي يصبح فيها الفرد عضوًا في المجتمع.
والحرّية في المجتمعات تنقلب إلى ظلم وعسف عندما تستأثر طبقة اقتصاديّة وفئات ميسورة واحدة بكل المغانم فتتحوّل حرّيتها إلى وسائل تضييق على الآخرين وتتوسّع حرّيتها بقدر انحسار رقعة حرّية الباقين.
فلا يمكن والحالة هذه أن يستقيم تصوّر قيام حرّية صحيحة إلّا بعد تحقيق العدالة الاجتماعيّة ووصول جميع المواطنين إلى حقوقهم في العيش اللائق بعيدًا عن الاحتكار والاستثمار والاستئثار.
وتعجز المجتمعات عن بلوغ غايتها هذه في العدالة الاجتماعيّة إلّا إذا أسندت مقدّراتها وإدارة شؤونها إلى حكومات تجعل في صميم برامجها تحرير المواطن من ربقات التسلّط الاقتصاديّ في مجتمعه.
فالديموقراطيّة الاجتماعيّة هي لون من ألوان الاشتراكيّة أو التكافليّة (solidarisme) التي تدعو الدولة إلى الالتزام الدائم وإلى التخطيط وإلى نبذ الحياد في الحكم وإلى السير نحو تطوير عميق في النظام السياسيّ والاجتماعيّ القائم.
والديموقراطيّة الاجتماعيّة على اقتناع تامّ بأنّ الحرّية _ في المجتمع الليبراليّ _ هي تغطية لتسلّط فئة طبقيّة مترفة على سائر أفراد المجتمع وأنّ مثل هذه الحرّية هي نوع من السراب وأنّ الحرّية الأصليّة هي التي تتولّد وتترعرع في كنف العدالة الاجتماعيّة المحقّقة في المجتمع ولا بدّ أن تكون تتويجًا لنظام عادل.
وفي مذهب الديموقراطيّة الاجتماعيّة إنّ الحرّية التي لا تصاحبها الطمأنينة الاجتماعيّة والاقتصاديّة هي طلاء وخداع وبهتان، وإنّ الحرّية الحقّة هي ثمرة العدالة وتأتي في أعقابها.
لذلك بات من الصواب القول بأنّ المفهومين في الديموقراطيّة يختلفان أساسًا من حيث نظرتهما إلى الحرّية. فالديموقراطيّة السياسيّة ترى أنّ الحرّية الفرديّة هي السبيل للوصول إلى العدالة الاجتماعيّة.
والديموقراطيّة الاجتماعيّة ترى أنّ الحرّية الفرديّة هي سراب ولغو لأكثريّة الشعب في مجتمع تحكمه طبقة اقتصاديّة وسياسيّة واحدة موسرة محتكرة وأنّ الحرّية الصحيحة هي النضال لإبدال مثل هذا المجتمع وأنّ الحرّية ليست في الواقع سوى التفلّت والتحرّر من طغيان وتحكّم مثل هذا المجتمع.
ومن يرقب مسيرة المحاماة وأثرها على الحياة العامّة في لبنان، يجد أنّها ما برحت ملتزمة دون انقطاع بالتعاليم الديموقراطيّة، المتقاسمة بين المفهوم السياسيّ والمفهوم الاجتماعيّ.
ولا يفوت المحاماة ما يثار في وجه الديموقراطيّة من المعايب والمطاعن التي تؤذي العقل والمنطق في العمليّة التطبيقيّة لها، لا سيما تلك التي توجب مثلًا بأن تسند السلطة إلى اختيار صادر عن خمسة أشخاص لأنهم تغلّبوا وربحوا ورجّحوا في التصويت على أربعة أشخاص آخرين، وإن كان الراجحون جميعهم من البلداء الخاملين، وكان المرجوحون أنداء ونظراء لسقراط ولقمان وتوما الأكويني وارسطاطاليس.
وقد ارتأت المحاماة وآثرت التعاطي مع الديموقراطيّة _ تفاديًا للجدل العقائديّ الواسع فيها _ ضمن إطار معطيات الثورة الفرنسيّة ملخّصة في الشعار المثلّث المتمثّل بالمساواة والحرّية والإخاء. وقد رسّخت مثل هذه المعاطاة لدى المحامين منذ الساعة التي تعمّد فيها الآباء المؤسّسون تنزيه النزاعات والمخاصمات الجارية بينهم ممّا يخشى أن يتداخلها من شحناء وتباغض. فحاولوا الارتفاع بآداب التخاصم المهنيّ إلى درجة غدا فيها مضاهيًا في مستوياته لأرقى ما تدلي به المباريات العلميّة والفكريّة _ ناهيك بالرياضيّة الدوليّة _ من تهذيب وانصقال.
ومن آيات التزام صفوة المحامين بعهد الترفّع والتجرّد يكفي أنّهم طوال خمسة وسبعين عامًا، حرصوا على أن لا يتداخل في رعاية منتدبيهم لشؤون النقابة أيّ معنى للأثرة والاستئثار، مما أضاف إلى الحياة الديموقراطيّة في لبنان بعدًا حضاريًا مرموقًا.
وجاء في عزوفهم عن البهرجة والزهرف وامتثالهم للخيار الديموقراطيّ وللتبديل الدوريّ المسند إلى الاقتراع الجماعيّ الموسميّ المتداول لديهم بدون انقطاع، ما يعيد إلى الأذهان تلك التعاليم اللبنانيّة العريقة التي أطلقها الفقيه اللبنانيّ الأمثل الإمام الأوزاعي في مناضلة طغاة العباسيّين المتعسّفين يومذاك على مواطنيه في الجبل اللبنانيّ، وهو الذي دعا أهل كلّ سلطة إلى التطلّع المستديم لقرب زوالها، منبّهًا إلى أنّ في زوال السلطة الطبيعيّ هناء ونعمة، وفي زوالها القسريّ شقاء ونقمة.
وفي سياق الرجوع إلى جذور الديموقراطيّة لدى العشيرة الواحدة في لبنان، لا بدّ من استذكار حقيقة تاريخيّة موطّدة، وهي أنّ المحاماة تأسّست في مستهلّ مسيرتها على قاعدة عفويّة من النخوة والمروءة وعلى ركائز خلقيّة عميقة، وذلك قبل أن تنتظمها النصوص في القوالب القانونيّة. ولعلّ الإطلالة الأولى التي اثبتت قيام اللفظة في المعجم العربيّ وردت على لسان الشاعر الجاهليّ القائل:
إنّا لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكماة ألا أين المحامونا!!
وبين الشهامة الممهّدة لولادة المحاماة والمتمثّلة بهذا النداء البدويّ الضارب في أعماق الفروسيّة بعيدًا في التاريخ، وبين الديموقراطيّة المستمدّة هويّتها من سجايا النجدة والإنصاف الداعيين إلى تكافؤ الفرص وإحقاق الحقّ بين الناس.
يطلّ المهرجان الماسي للمحامين في لبنان على مآثر نقابتيه الاثنتين التوأمين المتعافيتين، ويحمل في طيّاته دعوة إلى الاقتداء بماضٍ عريق عموديّ القامة، وآية استنهاض متطلّعة إلى مستقبل رائد، ومنعقدة على البذل والعطاء.
(يراجع في ذلك، نقابة المحامين، الكتاب الماسيّ، 1919_ 1994 ص 239)